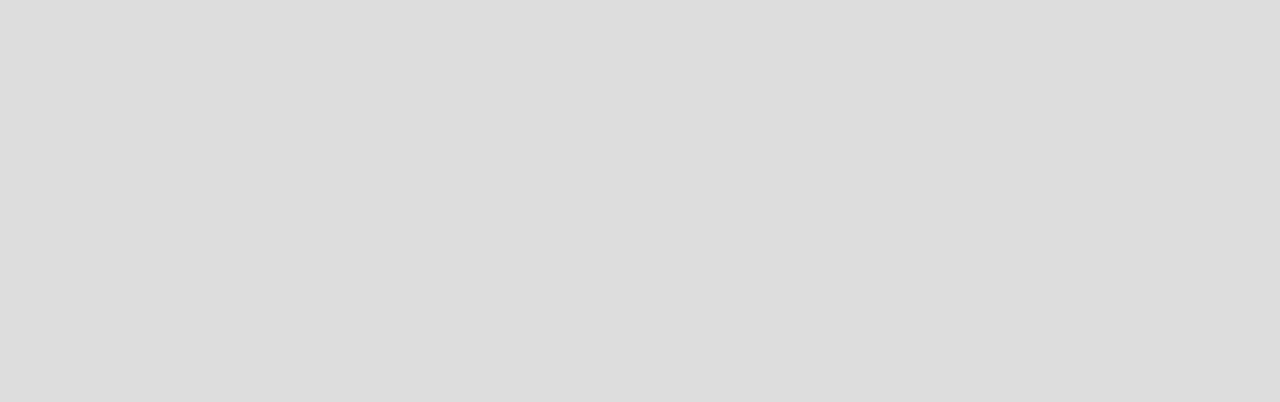بعد الفِراق

بقلم: سلافة سمباوه
التعلّق بعد الفِراق ظاهرة نفسية شائعة لا يمكن اختزالها في الضعف العاطفي أو العجز عن التجاوز.
تشير الأبحاث النفسية إلى أن الإنسان، حين يدخل علاقة عاطفية مستقرة نسبيًا، يُعيد تنظيم عالمه الداخلي حولها، فتتحول العلاقة إلى مرجعية نفسية يومية تنظّم الشعور بالأمان والانتماء وتقدير الذات.
وعندما تنتهي هذه العلاقة، لا يفقد الفرد شخصًا فقط، بل يفقد نظامًا نفسيًا اعتاد عليه، ما يفسّر حالة الارتباك والتمسّك التي تلي الفِراق.
من منظور علم الأعصاب، يرتبط التعلّق بآليات كيميائية معقّدة، حيث يُنشّط الحب دوائر المكافأة في الدماغ عبر إفراز الدوبامين والأوكسيتوسين.
هذه المواد تعزّز الشعور بالقرب والاطمئنان، ومع الانفصال ينخفض إفرازها فجأة، فيدخل الدماغ في حالة تشبه أعراض الانسحاب، تظهر على شكل أفكار قهرية، حنين متكرر، واضطراب في المزاج والنوم.
هذا التفاعل البيولوجي يفسّر لماذا يستمر التعلّق حتى في العلاقات التي كانت مؤذية أو غير متوازنة.
نفسيًا، يعمل الفِراق على تنشيط جروح أقدم لم تُحلّ سابقًا، خصوصًا لدى من عانوا من أنماط التعلّق القَلِق أو تجارب الهجر المبكر.
في هذه الحالات، لا يكون التعلّق موجّهًا إلى الشخص بحد ذاته، بل إلى الخوف من الفقدان وإعادة إحياء مشاعر قديمة مرتبطة بعدم الأمان.
ولهذا، يبدو الألم أحيانًا أكبر من حجم العلاقة نفسها، لأنه يحمل شحنة تراكمية من تجارب سابقة غير واعية.
تُظهر الدراسات السريرية اختلافًا نسبيًا في استجابة الرجل والمرأة للفِراق.
فالمرأة تميل غالبًا إلى مواجهة الألم بشكل مباشر، عبر التعبير والتحليل ومحاولة الفهم، بينما يميل الرجل إلى تأجيل المواجهة النفسية من خلال الانشغال أو الدخول في علاقة جديدة، وهو ما قد يمنحه شعورًا مؤقتًا بالتحسّن قبل أن يظهر التعلّق المؤجّل لاحقًا بصورة أكثر حدّة.
هذا الاختلاف لا يعكس عمقًا عاطفيًا متفاوتًا، بل أساليب دفاع نفسي مختلفة.
الدخول في علاقة جديدة بعد الفِراق لا يُعدّ بالضرورة سلوكًا خاطئًا من منظور نفسي، إلا أنه يصبح إشكاليًا حين يُستخدم كآلية هروب من الألم بدلًا من معالجته.
في هذه الحالة، يتحوّل الطرف الجديد إلى أداة تنظيم مؤقت للمشاعر، دون تفكيك التعلّق السابق، ما يؤدي غالبًا إلى تكرار أنماط غير صحية من الارتباط.
أما حين تُبنى العلاقة الجديدة بوعي وحدود واضحة، فقد تكون مساحة آمنة لإعادة التوازن العاطفي.
الشفاء النفسي من التعلّق لا يقوم على النسيان أو الإنكار، بل على إعادة تنظيم العلاقة بين الفرد واحتياجاته العاطفية. يبدأ ذلك بالاعتراف بالألم كاستجابة طبيعية، ثم بالتمييز بين الشخص الذي انتهت العلاقة معه، وبين الاحتياجات النفسية التي كان يلبيها.
ومع الوقت، تُعاد صياغة الهوية الفردية بعيدًا عن الارتباط السابق، ويستعيد الفرد شعوره بالسيطرة الداخلية والاستقرار.
تظهر علامات الشفاء عندما يتراجع الاندفاع العاطفي المرتبط بالذكرى، ويصبح استحضار العلاقة ممكنًا دون ألم جسدي أو توتر داخلي.
كما يتجلى التعافي في انخفاض الحاجة إلى المراقبة أو الانتظار، وعودة الاهتمام بالحياة اليومية والخيارات الشخصية.
في هذه المرحلة، لا يعود الفرد مدفوعًا بالبحث عن تعويض عاطفي سريع، بل يصبح أكثر قدرة على الاختيار الواعي لعلاقاته القادمة.
في المحصلة، التعلّق بعد الفِراق ليس خللًا نفسيًا، بل أثرًا طبيعيًا لانفصال لم يُعالَج على المستوى الداخلي بعد.
والشفاء الحقيقي لا تحققه الأيام وحدها، بل يتحقق عبر الفهم النفسي العميق، وبناء الحدود، واستعادة العلاقة مع الذات بوصفها المصدر الأول للأمان.
التعلّق بعد الفِراق ظاهرة نفسية شائعة لا يمكن اختزالها في الضعف العاطفي أو العجز عن التجاوز.
تشير الأبحاث النفسية إلى أن الإنسان، حين يدخل علاقة عاطفية مستقرة نسبيًا، يُعيد تنظيم عالمه الداخلي حولها، فتتحول العلاقة إلى مرجعية نفسية يومية تنظّم الشعور بالأمان والانتماء وتقدير الذات.
وعندما تنتهي هذه العلاقة، لا يفقد الفرد شخصًا فقط، بل يفقد نظامًا نفسيًا اعتاد عليه، ما يفسّر حالة الارتباك والتمسّك التي تلي الفِراق.
من منظور علم الأعصاب، يرتبط التعلّق بآليات كيميائية معقّدة، حيث يُنشّط الحب دوائر المكافأة في الدماغ عبر إفراز الدوبامين والأوكسيتوسين.
هذه المواد تعزّز الشعور بالقرب والاطمئنان، ومع الانفصال ينخفض إفرازها فجأة، فيدخل الدماغ في حالة تشبه أعراض الانسحاب، تظهر على شكل أفكار قهرية، حنين متكرر، واضطراب في المزاج والنوم.
هذا التفاعل البيولوجي يفسّر لماذا يستمر التعلّق حتى في العلاقات التي كانت مؤذية أو غير متوازنة.
نفسيًا، يعمل الفِراق على تنشيط جروح أقدم لم تُحلّ سابقًا، خصوصًا لدى من عانوا من أنماط التعلّق القَلِق أو تجارب الهجر المبكر.
في هذه الحالات، لا يكون التعلّق موجّهًا إلى الشخص بحد ذاته، بل إلى الخوف من الفقدان وإعادة إحياء مشاعر قديمة مرتبطة بعدم الأمان.
ولهذا، يبدو الألم أحيانًا أكبر من حجم العلاقة نفسها، لأنه يحمل شحنة تراكمية من تجارب سابقة غير واعية.
تُظهر الدراسات السريرية اختلافًا نسبيًا في استجابة الرجل والمرأة للفِراق.
فالمرأة تميل غالبًا إلى مواجهة الألم بشكل مباشر، عبر التعبير والتحليل ومحاولة الفهم، بينما يميل الرجل إلى تأجيل المواجهة النفسية من خلال الانشغال أو الدخول في علاقة جديدة، وهو ما قد يمنحه شعورًا مؤقتًا بالتحسّن قبل أن يظهر التعلّق المؤجّل لاحقًا بصورة أكثر حدّة.
هذا الاختلاف لا يعكس عمقًا عاطفيًا متفاوتًا، بل أساليب دفاع نفسي مختلفة.
الدخول في علاقة جديدة بعد الفِراق لا يُعدّ بالضرورة سلوكًا خاطئًا من منظور نفسي، إلا أنه يصبح إشكاليًا حين يُستخدم كآلية هروب من الألم بدلًا من معالجته.
في هذه الحالة، يتحوّل الطرف الجديد إلى أداة تنظيم مؤقت للمشاعر، دون تفكيك التعلّق السابق، ما يؤدي غالبًا إلى تكرار أنماط غير صحية من الارتباط.
أما حين تُبنى العلاقة الجديدة بوعي وحدود واضحة، فقد تكون مساحة آمنة لإعادة التوازن العاطفي.
الشفاء النفسي من التعلّق لا يقوم على النسيان أو الإنكار، بل على إعادة تنظيم العلاقة بين الفرد واحتياجاته العاطفية. يبدأ ذلك بالاعتراف بالألم كاستجابة طبيعية، ثم بالتمييز بين الشخص الذي انتهت العلاقة معه، وبين الاحتياجات النفسية التي كان يلبيها.
ومع الوقت، تُعاد صياغة الهوية الفردية بعيدًا عن الارتباط السابق، ويستعيد الفرد شعوره بالسيطرة الداخلية والاستقرار.
تظهر علامات الشفاء عندما يتراجع الاندفاع العاطفي المرتبط بالذكرى، ويصبح استحضار العلاقة ممكنًا دون ألم جسدي أو توتر داخلي.
كما يتجلى التعافي في انخفاض الحاجة إلى المراقبة أو الانتظار، وعودة الاهتمام بالحياة اليومية والخيارات الشخصية.
في هذه المرحلة، لا يعود الفرد مدفوعًا بالبحث عن تعويض عاطفي سريع، بل يصبح أكثر قدرة على الاختيار الواعي لعلاقاته القادمة.
في المحصلة، التعلّق بعد الفِراق ليس خللًا نفسيًا، بل أثرًا طبيعيًا لانفصال لم يُعالَج على المستوى الداخلي بعد.
والشفاء الحقيقي لا تحققه الأيام وحدها، بل يتحقق عبر الفهم النفسي العميق، وبناء الحدود، واستعادة العلاقة مع الذات بوصفها المصدر الأول للأمان.