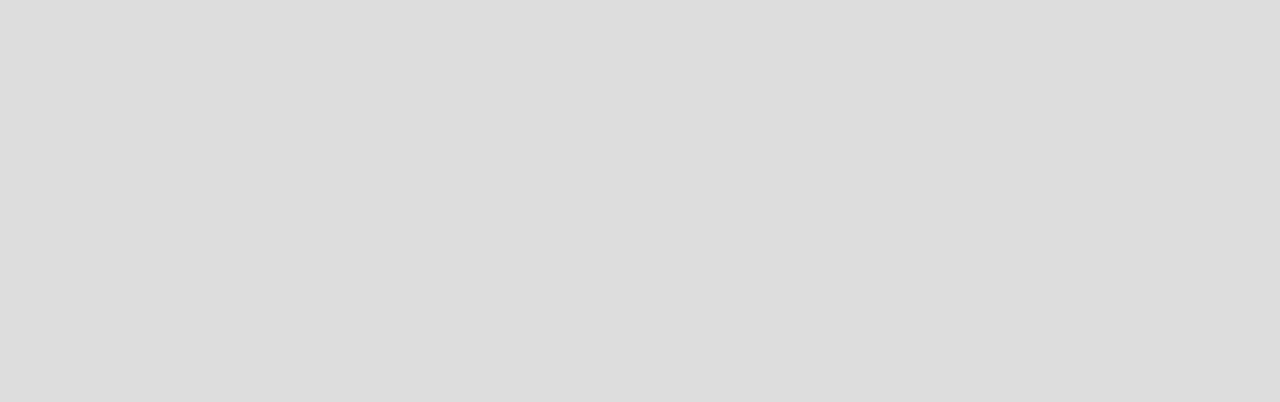"مجتمعٌ مجامل... يكره الحقيقة ويُحب القناع"

حين يصقل المجتمع بالمجاملات، ويتربى على "قل خيرًا أو اصمت"، يصبح الصمت فضيلة، والكذب ذوقًا، والصراحة طيشًا لا يُغتفر.
نعيش في واقعٍ نُخفي فيه الرفض بابتسامة، وندفن فيه النصيحة تحت ألف تبرير، ونربّت على أكتاف الخطأ بحجة: "لا تحرجه".
فهل نحن طيبون حقًا؟ أم أننا مجرد مجتمعٍ مجامل... يكره الحقيقة، ويُحب القناع؟
لقد تحوّلت المجاملة من خُلق رفيع إلى سلوك دفاعي جماعي نمارسه اتقاءً لصدام، أو طلبًا لسلام مؤقت، أو حفظًا لماء وجهٍ هش.
لكننا لم نسأل أنفسنا: كم مرة ساهمنا في تضخيم باطل بصمتنا؟ كم قرارًا خاطئًا باركناه بالكفّ عن النقد؟ كم شخصًا أضعناه حين لم نُصارحه بما ينبغي؟
حين تصبح المجاملة نمط حياة، يفقد المجتمع مناعته الأخلاقية... ويعيش بأقنعة تبتسم، بينما الحقيقة تنزف في الخلف.
في العمل... الولاء للمُجامل لا للمُنجز
تُمنح الترقيات لمن يتقن فن "السكوت المناسب"، وتُختار القيادات بناءً على الطاعة لا الكفاءة.
من يصارح مدراءه، يُؤخذ عليه أنه "ناقل سلبيات"، بينما من يُجامل الخطأ، يُكافأ على "روح الفريق"!
وهكذا تُدار مؤسساتنا أحيانًا بالمشاعر، لا بالمؤشرات.
في العلاقات الاجتماعية... المجاملة تقتل المودة
نحضر مناسبات لا نرغبها، ونضحك لمواقف لا تضحك، ونثني على أطعمة لا تُؤكل، ونُجامِل حتى في الموت!
الصديق لا يُنصح، بل يُساير.
الجار يُبتسم له، لكن يُشتكى منه في المجالس.
فهل هذه علاقات؟ أم هدنة مؤقتة بين متخاصمين؟
في التربية... نخشى المصارحة فنُخرّج أجيالًا هشة
في البيت، نُخفي مشاعرنا عن أبنائنا، ونُشجّعهم على "القبول بكل شيء" باسم الأدب.
نمنعهم من السؤال، ونسميه "وقاحة".
نُعلّمهم أن المجاملة أولى من الصدق، فيشبّون خائفين من قول الحقيقة، عاجزين عن خوض نقاش.
في الدين... نخاف أن نُذكّر، فنصمت
كم من سلوك خاطئ نراه، فنتجاهله؟
كم من منكر نعرفه، ونتجاوزه بحجة "ما لي شغل"؟
أليس من الأمانة أن نُصلح لا أن نُساير؟ أن نقول الكلمة الطيبة، لا أن نبتلعها في صحن المجاملة؟
هل نريد أن نُصلح، أم نُرضي؟
نعيش في واقعٍ نُخفي فيه الرفض بابتسامة، وندفن فيه النصيحة تحت ألف تبرير، ونربّت على أكتاف الخطأ بحجة: "لا تحرجه".
فهل نحن طيبون حقًا؟ أم أننا مجرد مجتمعٍ مجامل... يكره الحقيقة، ويُحب القناع؟
لقد تحوّلت المجاملة من خُلق رفيع إلى سلوك دفاعي جماعي نمارسه اتقاءً لصدام، أو طلبًا لسلام مؤقت، أو حفظًا لماء وجهٍ هش.
لكننا لم نسأل أنفسنا: كم مرة ساهمنا في تضخيم باطل بصمتنا؟ كم قرارًا خاطئًا باركناه بالكفّ عن النقد؟ كم شخصًا أضعناه حين لم نُصارحه بما ينبغي؟
حين تصبح المجاملة نمط حياة، يفقد المجتمع مناعته الأخلاقية... ويعيش بأقنعة تبتسم، بينما الحقيقة تنزف في الخلف.
في العمل... الولاء للمُجامل لا للمُنجز
تُمنح الترقيات لمن يتقن فن "السكوت المناسب"، وتُختار القيادات بناءً على الطاعة لا الكفاءة.
من يصارح مدراءه، يُؤخذ عليه أنه "ناقل سلبيات"، بينما من يُجامل الخطأ، يُكافأ على "روح الفريق"!
وهكذا تُدار مؤسساتنا أحيانًا بالمشاعر، لا بالمؤشرات.
في العلاقات الاجتماعية... المجاملة تقتل المودة
نحضر مناسبات لا نرغبها، ونضحك لمواقف لا تضحك، ونثني على أطعمة لا تُؤكل، ونُجامِل حتى في الموت!
الصديق لا يُنصح، بل يُساير.
الجار يُبتسم له، لكن يُشتكى منه في المجالس.
فهل هذه علاقات؟ أم هدنة مؤقتة بين متخاصمين؟
في التربية... نخشى المصارحة فنُخرّج أجيالًا هشة
في البيت، نُخفي مشاعرنا عن أبنائنا، ونُشجّعهم على "القبول بكل شيء" باسم الأدب.
نمنعهم من السؤال، ونسميه "وقاحة".
نُعلّمهم أن المجاملة أولى من الصدق، فيشبّون خائفين من قول الحقيقة، عاجزين عن خوض نقاش.
في الدين... نخاف أن نُذكّر، فنصمت
كم من سلوك خاطئ نراه، فنتجاهله؟
كم من منكر نعرفه، ونتجاوزه بحجة "ما لي شغل"؟
أليس من الأمانة أن نُصلح لا أن نُساير؟ أن نقول الكلمة الطيبة، لا أن نبتلعها في صحن المجاملة؟
هل نريد أن نُصلح، أم نُرضي؟