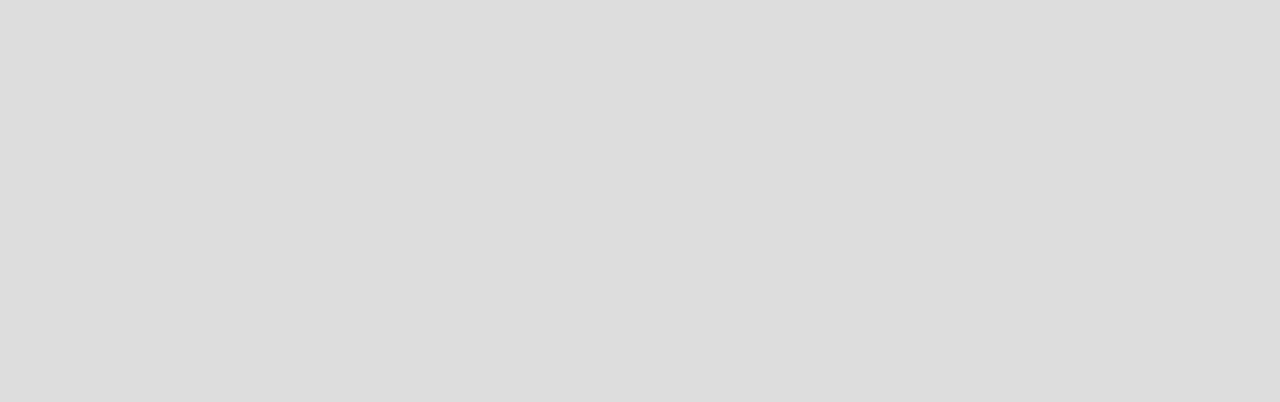حين أُطفِئَت المصابيح

بقلم / لينا عبدالغفور
في لحظة انطفاء، اكتشف أن الضوء الذي كان يغمره لم يكن يومًا منه.
كانت المصابيح تعكس زيفه لا صدقه، حتى قادته العتمة إلى الحقيقة التي طالما خافها.
كان يشبه الضوء، أو هكذا بدا لهم.
يمشي بينهم بخطى واثقة، يوزّع الوهج في كل اتجاه،
ويترك خلفه ظلالًا تظنها أثر النور، لكنها كانت امتدادًا لظلامٍ يعرف طريقه جيدًا.
لم يكن النور في داخله، بل على وجهه فقط،
كطلاءٍ صُنع بإتقان ليخفي تصدّع الروح من الداخل.
اعتاد أن يعيش بين الأعين المبهورة به،
تلك التي تُصدّق كل ما يلمع.
كان يظن أن الضوء يمنحه مكانةً، وأن السطوع يحميه من العتمة،
فأصبح أسيرًا لدورٍ لم يعد يعرف كيف يخرج منه.
كان يضيء الآخرين ليظل هو في الظل،
ويضحك كي لا يُرى حزنه.
وفي ليلةٍ عابرة، انطفأت المصابيح من حوله.
غابت الأعين التي كانت تعكس عليه بريقها،
فسقط فجأة في صمتٍ كثيف لا يُرى فيه شيء.
هناك، وسط العتمة التي طالما خافها،
رأى وجهه الحقيقي للمرة الأولى.
كان باهتًا، خاليًا من الوهج،
لكن فيه صدقًا لم يعرفه من قبل.
جلس طويلًا يراقب ظله،
الذي لم يكن يومًا عدوَّه كما ظن،
بل دليله الوحيد إلى الحقيقة.
فهم أن الظلام لا يخدع،
وأن النور حين يفقد صدقه يصبح أكثر تضليلًا من أي ظلمة.
فالضوء ليس فضيلةً بحد ذاته، بل هو كالكلمة،
تكتسب قيمتها من نية من ينطقها، لا من سطوعها.
تأمل حياته، وكل دورٍ لعبه باسم الإنارة،
كيف كان يخفي هشاشته بوميضٍ زائف،
ويقنع نفسه أنه يضيء الطريق، بينما كان يضلله.
أدرك أن النور الحقيقي لا يُستعار من نظرات الآخرين،
ولا يُخلق من التصفيق،
بل يولد من صدقٍ داخلي،
من لحظة مواجهةٍ بين الإنسان وظله.
نهض في الصباح التالي دون أن يبحث عن الضوء.
لم يعد يحتاجه كما كان،
فقد تعلّم أن العتمة التي عرفها أمس
أنارت له الطريق أكثر من كل المصابيح التي حملها في سنواته الماضية.
لم يعد الرجل المتخفي بدور الإنارة،
بل صار إنسانًا يرى في الظل جمال البقاء،
وفي الصدق وهجًا لا يخفت،
وفي السكون ضوءًا لا يُرى، لكنه يُشعر به.
ومنذ تلك الليلة،
لم يعد يهمه أن يُضيء للناس،
بل أن يظل منيرًا بما يكفي ليعرف أين يضع خطاه.
فالنور الذي يولد من الداخل لا يحتاج جمهورًا،
ولا يخاف العتمة،
لأن من صدق مع نفسه،
صار هو ذاته مصدر الضوء.
كانت المصابيح تعكس زيفه لا صدقه، حتى قادته العتمة إلى الحقيقة التي طالما خافها.
كان يشبه الضوء، أو هكذا بدا لهم.
يمشي بينهم بخطى واثقة، يوزّع الوهج في كل اتجاه،
ويترك خلفه ظلالًا تظنها أثر النور، لكنها كانت امتدادًا لظلامٍ يعرف طريقه جيدًا.
لم يكن النور في داخله، بل على وجهه فقط،
كطلاءٍ صُنع بإتقان ليخفي تصدّع الروح من الداخل.
اعتاد أن يعيش بين الأعين المبهورة به،
تلك التي تُصدّق كل ما يلمع.
كان يظن أن الضوء يمنحه مكانةً، وأن السطوع يحميه من العتمة،
فأصبح أسيرًا لدورٍ لم يعد يعرف كيف يخرج منه.
كان يضيء الآخرين ليظل هو في الظل،
ويضحك كي لا يُرى حزنه.
وفي ليلةٍ عابرة، انطفأت المصابيح من حوله.
غابت الأعين التي كانت تعكس عليه بريقها،
فسقط فجأة في صمتٍ كثيف لا يُرى فيه شيء.
هناك، وسط العتمة التي طالما خافها،
رأى وجهه الحقيقي للمرة الأولى.
كان باهتًا، خاليًا من الوهج،
لكن فيه صدقًا لم يعرفه من قبل.
جلس طويلًا يراقب ظله،
الذي لم يكن يومًا عدوَّه كما ظن،
بل دليله الوحيد إلى الحقيقة.
فهم أن الظلام لا يخدع،
وأن النور حين يفقد صدقه يصبح أكثر تضليلًا من أي ظلمة.
فالضوء ليس فضيلةً بحد ذاته، بل هو كالكلمة،
تكتسب قيمتها من نية من ينطقها، لا من سطوعها.
تأمل حياته، وكل دورٍ لعبه باسم الإنارة،
كيف كان يخفي هشاشته بوميضٍ زائف،
ويقنع نفسه أنه يضيء الطريق، بينما كان يضلله.
أدرك أن النور الحقيقي لا يُستعار من نظرات الآخرين،
ولا يُخلق من التصفيق،
بل يولد من صدقٍ داخلي،
من لحظة مواجهةٍ بين الإنسان وظله.
نهض في الصباح التالي دون أن يبحث عن الضوء.
لم يعد يحتاجه كما كان،
فقد تعلّم أن العتمة التي عرفها أمس
أنارت له الطريق أكثر من كل المصابيح التي حملها في سنواته الماضية.
لم يعد الرجل المتخفي بدور الإنارة،
بل صار إنسانًا يرى في الظل جمال البقاء،
وفي الصدق وهجًا لا يخفت،
وفي السكون ضوءًا لا يُرى، لكنه يُشعر به.
ومنذ تلك الليلة،
لم يعد يهمه أن يُضيء للناس،
بل أن يظل منيرًا بما يكفي ليعرف أين يضع خطاه.
فالنور الذي يولد من الداخل لا يحتاج جمهورًا،
ولا يخاف العتمة،
لأن من صدق مع نفسه،
صار هو ذاته مصدر الضوء.