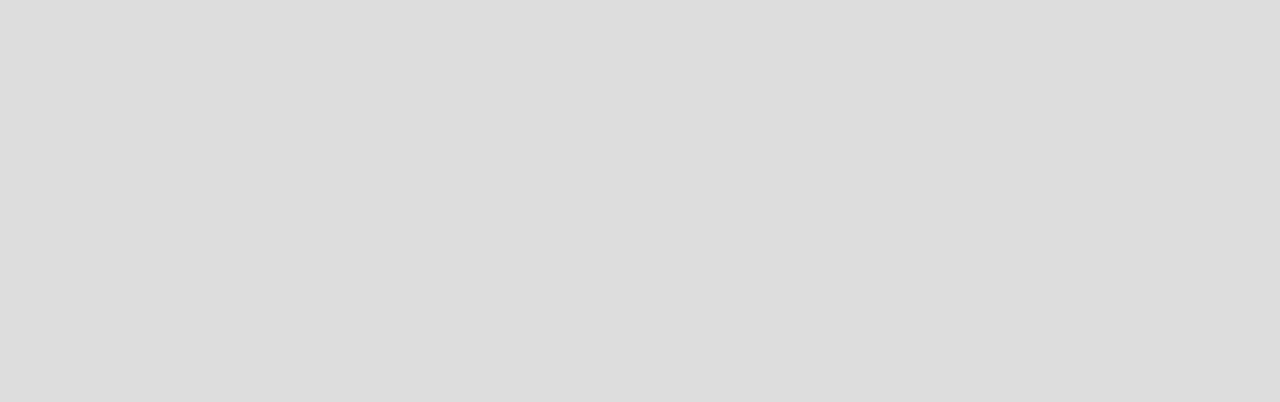الأطلال… حين يسكننا الماضي أكثر مما نسكنه

بقلم : ✍️ عامر آل عامر
في زوايا الصمت، تقف الأطلال شامخة كأنها تراقب الزمن من علٍ، لا تشيخ، لا تبوح، لكنها تفتح في القلب نوافذ الذكرى. هناك، حيث تعلّم الإنسان أول حروف الحنين، يولد البكاء على الأطلال ليس كضعفٍ، بل كطقسٍ إنساني عميق يعترف بأن للمكان ذاكرة، وللزمان روحًا لا تُنسى.
كل حجرٍ في أطلالنا يحمل سيرة وجه، وكل شقٍ في الجدار يحكي قصة حبٍ أو حلمٍ لم يكتمل.
ليست الأطلال حجارة صامتة كما يتوهم العابرون، بل أرواح ساكنة في جسد المكان.
من يقترب منها يسمع همسها، ومن ينصت جيدًا يشعر أن الجدران تبكي معه، وتغسل صدى الغياب بدموع الحنين.
البكاء على الأطلال لا يعني التعلق بالماضي، بل هو احتجاجٌ نبيل على قسوة النسيان.
فالأطلال مرآةٌ صادقةٌ تكشف وجه الإنسان حين كان نقيًا، حين كانت الخطوة الأولى في الحياة تحمل دهشة الطفولة، ونقاء الحب، وبساطة الفرح.
هناك، عند أول عتبة مهجورة، يعيد القلب ترتيب فصوله القديمة كما لو أنه يكتب سيرةً لم تكتمل.
الدهشة أن الأطلال لا تطلب منّا شيئًا.
لا ترجونا البقاء ولا تلومنا على الرحيل.
لكنها تعرف كيف تزرع فينا رعشة الفقد، وتوقظ فينا ذلك الصوت العميق الذي كدنا ننساه.
وكأنها تقول لنا: “أنتم من رحل، ونحن من بقينا نحرس الذكرى”.
ليس غريبًا أن الشعراء منذ الجاهلية وحتى اليوم بكوا على الأطلال، لأنهم أدركوا أن الحنين هو اللغة الوحيدة التي لا يشيخ صوتها.
الأطلال ليست ماضياً مات، بل ذاكرة تحيا فينا كلما حاولنا الهرب من أنفسنا.
في زمنٍ يركض بسرعة الضوء، تبقى الأطلال حارسًا نبيلًا للحظةٍ لم تعد.
تبقى شاهدة على أن الإنسان مهما تقدّم، يعود في نهاية الطريق ليبكي على حجرٍ صامت.. لأنه يعلم في قرارة قلبه أن الصمت أحيانًا أبلغ من الكلام.
هذا هو سر الأطلال: أنها لا تُنسى… لأنها ليست مكانًا فقط، بل وطنًا صغيرًا يسكن فينا.
إن البكاء على الأطلال ليس رجوعًا إلى الوراء، بل عودة إلى أنفسنا الحقيقية… إلى تلك النسخة النقيّة التي غمرها الغبار مع مرور الزمن. الأطلال لا تطلب منا أن نبكي، لكنها تذكّرنا بأن ما يجعل الإنسان إنسانًا هو قدرته على الشعور، والاعتراف، والوفاء لما مضى.
من يقف أمام الأطلال يدرك أن الحنين ليس ضعفًا، بل لغة سامية لا يتقنها إلا من عرف قيمة اللحظة حين كانت تنبض بالحياة.
وما دمنا قادرين على البكاء على أطلالنا، فهذا يعني أن قلوبنا ما زالت تنبض، وأن في أعماقنا جزءًا نقيًا يرفض أن يموت.
فالأطلال ليست نهاية الحكاية… بل بداية الوعي بأن ما يبقى حقًا، ليس الحجر ولا الجدار، بل الشعور الذي سكن المكان.
كل حجرٍ في أطلالنا يحمل سيرة وجه، وكل شقٍ في الجدار يحكي قصة حبٍ أو حلمٍ لم يكتمل.
ليست الأطلال حجارة صامتة كما يتوهم العابرون، بل أرواح ساكنة في جسد المكان.
من يقترب منها يسمع همسها، ومن ينصت جيدًا يشعر أن الجدران تبكي معه، وتغسل صدى الغياب بدموع الحنين.
البكاء على الأطلال لا يعني التعلق بالماضي، بل هو احتجاجٌ نبيل على قسوة النسيان.
فالأطلال مرآةٌ صادقةٌ تكشف وجه الإنسان حين كان نقيًا، حين كانت الخطوة الأولى في الحياة تحمل دهشة الطفولة، ونقاء الحب، وبساطة الفرح.
هناك، عند أول عتبة مهجورة، يعيد القلب ترتيب فصوله القديمة كما لو أنه يكتب سيرةً لم تكتمل.
الدهشة أن الأطلال لا تطلب منّا شيئًا.
لا ترجونا البقاء ولا تلومنا على الرحيل.
لكنها تعرف كيف تزرع فينا رعشة الفقد، وتوقظ فينا ذلك الصوت العميق الذي كدنا ننساه.
وكأنها تقول لنا: “أنتم من رحل، ونحن من بقينا نحرس الذكرى”.
ليس غريبًا أن الشعراء منذ الجاهلية وحتى اليوم بكوا على الأطلال، لأنهم أدركوا أن الحنين هو اللغة الوحيدة التي لا يشيخ صوتها.
الأطلال ليست ماضياً مات، بل ذاكرة تحيا فينا كلما حاولنا الهرب من أنفسنا.
في زمنٍ يركض بسرعة الضوء، تبقى الأطلال حارسًا نبيلًا للحظةٍ لم تعد.
تبقى شاهدة على أن الإنسان مهما تقدّم، يعود في نهاية الطريق ليبكي على حجرٍ صامت.. لأنه يعلم في قرارة قلبه أن الصمت أحيانًا أبلغ من الكلام.
هذا هو سر الأطلال: أنها لا تُنسى… لأنها ليست مكانًا فقط، بل وطنًا صغيرًا يسكن فينا.
إن البكاء على الأطلال ليس رجوعًا إلى الوراء، بل عودة إلى أنفسنا الحقيقية… إلى تلك النسخة النقيّة التي غمرها الغبار مع مرور الزمن. الأطلال لا تطلب منا أن نبكي، لكنها تذكّرنا بأن ما يجعل الإنسان إنسانًا هو قدرته على الشعور، والاعتراف، والوفاء لما مضى.
من يقف أمام الأطلال يدرك أن الحنين ليس ضعفًا، بل لغة سامية لا يتقنها إلا من عرف قيمة اللحظة حين كانت تنبض بالحياة.
وما دمنا قادرين على البكاء على أطلالنا، فهذا يعني أن قلوبنا ما زالت تنبض، وأن في أعماقنا جزءًا نقيًا يرفض أن يموت.
فالأطلال ليست نهاية الحكاية… بل بداية الوعي بأن ما يبقى حقًا، ليس الحجر ولا الجدار، بل الشعور الذي سكن المكان.