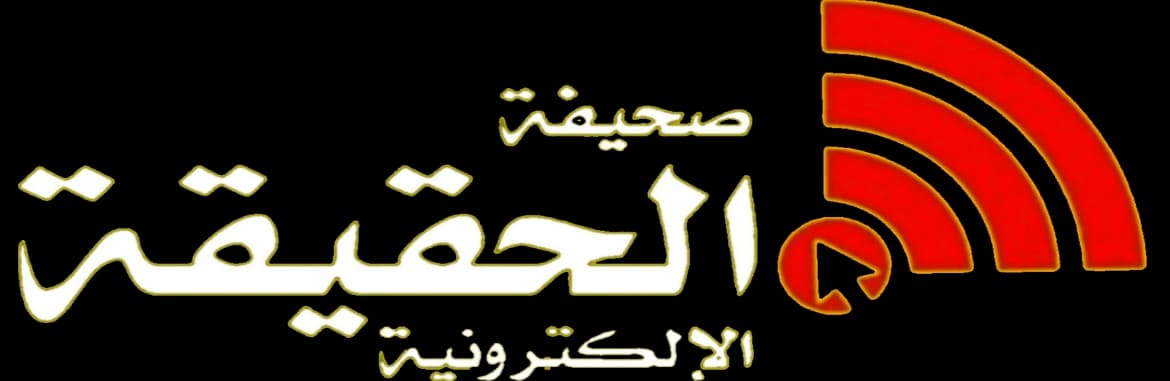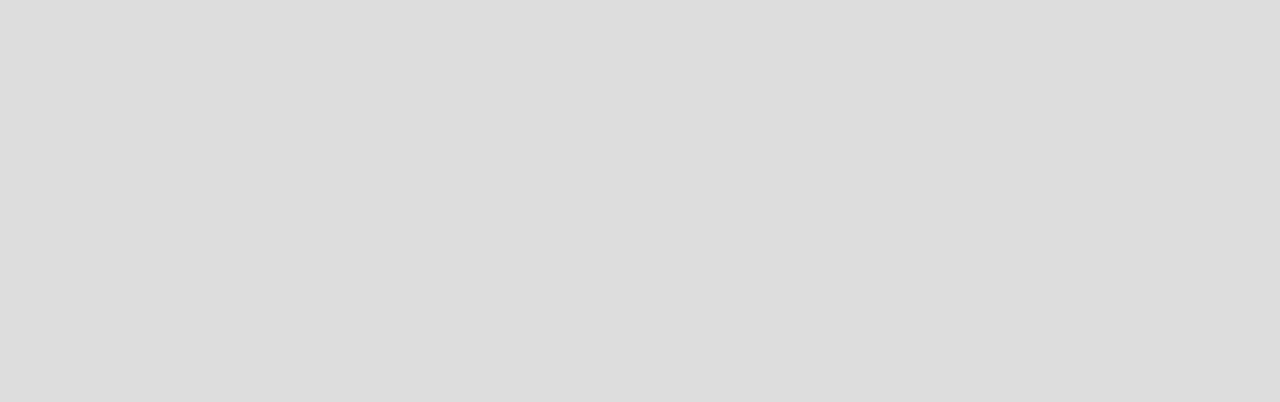مسيرة العمران الإنساني من القبيلة إلى العائلة

بقلم : عبدالعزيز الرحيل
الحمد لله الذي جعل الاجتماع الإنساني فطرة، وربط القلوب برباط المودّة والرحمة، وجعل البيوت سكنًا، والقرابة سترًا، والأنس بالآخرين حياةً للروح، وحصنًا من وحشة الوحدة.
قال الله تعالى:
“وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا” [النحل: 80]
آية بليغة تفيض إشراقًا، تذكّر العقول بأن البيت ليس خشبًا وحجارة، بل مأوى الأرواح وملاذ القلوب، ومصنع القيم وميدان التربية.
ومنذ أن خطّت قدم الإنسان على تراب الأرض، لم يكن منفردًا في مسيره، بل استظلّ براية الجماعة، فكانت القبيلة أمه الأولى، ودرعه الواقية، تلمّ شعثه وتؤنس وحشته، يجتمع فيها على الحماية والمروءة، ويقتسم فيها اللقمة والدمعة. وقد قال الشاعر في فخر الانتماء:
وإذا القومُ قالوا مَن فتىً؟ خِلتُ أنّني
عُنيتُ فلم أَكسَلْ ولم أتَبَلَّدِ
ثم جرت سنّة العمران بتبدّل أطواره، فانحسرت القبيلة إلى العائلة الممتدة، تضم الجدّ والأبناء والأحفاد تحت سقف واحد، وتربطهم موائد الطعام ومواريث الأرض، يظلّلهم كِبراء القوم بحكمتهم وسلطانهم. ومع قيام المدن، وتغيّر أسباب المعاش، واشتداد نزعة الاستقلال، وُلدت العائلة النووية: بيت صغير يجمع الأب والأم والذرية وحدهم، حيث القرار ذاتي، والحياة أكثر خصوصية، والاعتماد على النفس أوضح.
إلا أن هذه النقلة لم تخلُ من فقدان؛ ففي القبيلة، كان الهمّ واحدًا، والحلم مشتركًا، أما في العائلة النووية، فالدوائر أضيق، والروابط أقل كثافة، وصوت الفرد أعلى من جوقة الجماعة.
وفي ميزان الفلسفة، القبيلة مثال “المجتمع الحامي” الذي يقدّم المصلحة العامة على الخاصة، أما العائلة النووية فهي صورة “المجتمع الذاتي” حيث الفرد هو محور الدائرة. فالتاريخ متحوّل كالماء الجاري، لا يعود على صورته الأولى.
وهكذا، فإن رحلة الإنسان من القبيلة إلى العائلة النووية، أشبه بمسار النهر من منبعه إلى مصبّه؛ يبدأ عريضًا في سعة الجماعة، ثم يضيق في انفراد المجرى، لكنه لا ينقطع عن جوهره الأزلي: طلب الأمان والانتماء.
ويبقى السؤال قائمًا بين الأمس واليوم: أَنَحنُ في عصرنا أوسع حريةً، أم أفقر دفئًا..
قال الله تعالى:
“وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا” [النحل: 80]
آية بليغة تفيض إشراقًا، تذكّر العقول بأن البيت ليس خشبًا وحجارة، بل مأوى الأرواح وملاذ القلوب، ومصنع القيم وميدان التربية.
ومنذ أن خطّت قدم الإنسان على تراب الأرض، لم يكن منفردًا في مسيره، بل استظلّ براية الجماعة، فكانت القبيلة أمه الأولى، ودرعه الواقية، تلمّ شعثه وتؤنس وحشته، يجتمع فيها على الحماية والمروءة، ويقتسم فيها اللقمة والدمعة. وقد قال الشاعر في فخر الانتماء:
وإذا القومُ قالوا مَن فتىً؟ خِلتُ أنّني
عُنيتُ فلم أَكسَلْ ولم أتَبَلَّدِ
ثم جرت سنّة العمران بتبدّل أطواره، فانحسرت القبيلة إلى العائلة الممتدة، تضم الجدّ والأبناء والأحفاد تحت سقف واحد، وتربطهم موائد الطعام ومواريث الأرض، يظلّلهم كِبراء القوم بحكمتهم وسلطانهم. ومع قيام المدن، وتغيّر أسباب المعاش، واشتداد نزعة الاستقلال، وُلدت العائلة النووية: بيت صغير يجمع الأب والأم والذرية وحدهم، حيث القرار ذاتي، والحياة أكثر خصوصية، والاعتماد على النفس أوضح.
إلا أن هذه النقلة لم تخلُ من فقدان؛ ففي القبيلة، كان الهمّ واحدًا، والحلم مشتركًا، أما في العائلة النووية، فالدوائر أضيق، والروابط أقل كثافة، وصوت الفرد أعلى من جوقة الجماعة.
وفي ميزان الفلسفة، القبيلة مثال “المجتمع الحامي” الذي يقدّم المصلحة العامة على الخاصة، أما العائلة النووية فهي صورة “المجتمع الذاتي” حيث الفرد هو محور الدائرة. فالتاريخ متحوّل كالماء الجاري، لا يعود على صورته الأولى.
وهكذا، فإن رحلة الإنسان من القبيلة إلى العائلة النووية، أشبه بمسار النهر من منبعه إلى مصبّه؛ يبدأ عريضًا في سعة الجماعة، ثم يضيق في انفراد المجرى، لكنه لا ينقطع عن جوهره الأزلي: طلب الأمان والانتماء.
ويبقى السؤال قائمًا بين الأمس واليوم: أَنَحنُ في عصرنا أوسع حريةً، أم أفقر دفئًا..