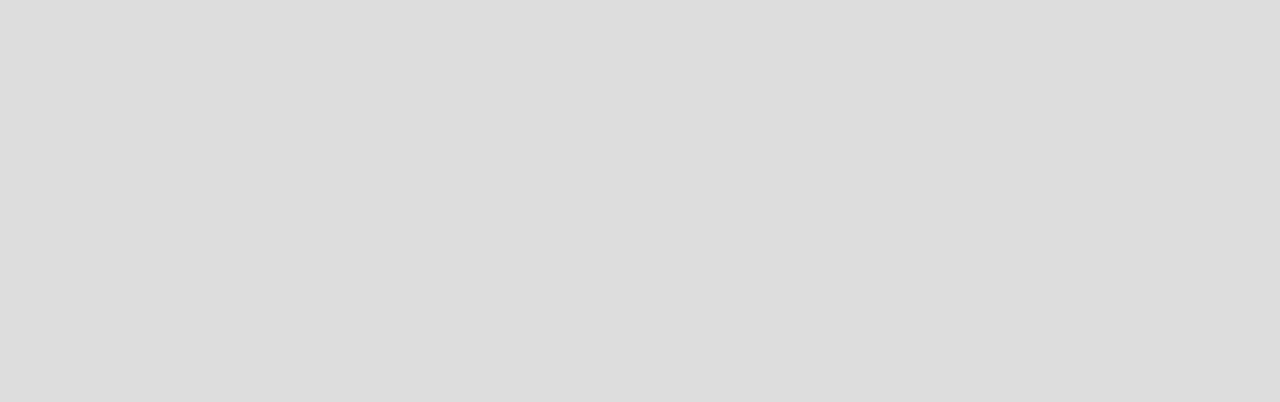رتابة اللقاءات الأدبية

بقلم / سلافة سمباوه
اللقاءات الأدبية، في أصلها، وُجدت لتكون مساحة حوار حي، ومجالًا لاكتشاف النصوص والأفكار، لا مجرد تجمعات متشابهة تتكرر فيها الوجوه والمواضيع والأساليب. غير أن كثيرًا من هذه اللقاءات تحوّل مع الوقت إلى حالة من الرتابة، أفقدت الأدب دهشته، وحوّلت الحوار إلى طقس اجتماعي أكثر منه فعلًا ثقافيًا.
تتجلى هذه الرتابة حين تُستضاف الأسماء ذاتها، وتُناقش الأفكار نفسها، وتُعاد المواضيع نفسها بصياغات مختلفة. يصبح اللقاء متوقعًا، ويغيب عنصر المفاجأة، ويتحوّل الحضور إلى جمهور يعرف مسبقًا ما سيُقال. ومع هذا التكرار، تسود المجاملات، ويختفي النقاش الحقيقي، ويُقدَّم الخطاب الأدبي في صورة أقرب إلى الوعظ أو التلقين.
المشهد داخل هذه اللقاءات لا يكون متجانسًا. فهناك من يحضر دون فهم حقيقي لما يُطرح، إما بدافع الظهور أو المجاملة الاجتماعية، وهناك من يأتي برغبة صادقة في التعلم والمعرفة. لكن وسط الزحام، وطول الحديث، وغياب التنظيم، يفقد كثيرون قدرتهم على التركيز أو الفهم، فتضيع الفائدة، ويتحوّل الحضور من مشاركة واعية إلى مجرد وجود جسدي.
تزداد الإشكالية حين يكون أسلوب الضيف نفسه طاردًا. حديث طويل، لغة معقدة، أو استعراض للتجربة دون مراعاة للمتلقي. ورغم شعور الملل، يجد الحضور أنفسهم مضطرين إلى المجاملة، والتصفيق، وإبداء الإعجاب، لا لأن ما قُدّم كان ملهمًا، بل لأن ثقافة المجاملة أصبحت جزءًا من المشهد الأدبي.
المشكلة لا تكمن في اختلاف مستويات الحضور، فهذا طبيعي، بل في إدارة اللقاءات دون مراعاة لهذا التنوع. حين يُفترض أن يفهم الجميع المستوى نفسه، وحين يُترك الحوار دون توجيه، تضيع الفكرة، ويُقصى من جاء بحثًا عن المعرفة الحقيقية.
اللقاء الأدبي الناجح هو الذي يوازن بين العمق والبساطة، ويمنح الحضور مساحة للفهم والسؤال، لا مجرد الاستماع الصامت. هو لقاء يُدار بحس ثقافي، لا بروتين مكرر، ويقدّم الأدب بوصفه تجربة حية، لا واجبًا اجتماعيًا.
رتابة اللقاءات الأدبية ليست قدرًا محتومًا، لكنها نتيجة خيارات. وحين تُراجع هذه الخيارات بوعي، يمكن للأدب أن يستعيد مكانه كمساحة للدهشة، لا كمنصة للمجاملات.
تتجلى هذه الرتابة حين تُستضاف الأسماء ذاتها، وتُناقش الأفكار نفسها، وتُعاد المواضيع نفسها بصياغات مختلفة. يصبح اللقاء متوقعًا، ويغيب عنصر المفاجأة، ويتحوّل الحضور إلى جمهور يعرف مسبقًا ما سيُقال. ومع هذا التكرار، تسود المجاملات، ويختفي النقاش الحقيقي، ويُقدَّم الخطاب الأدبي في صورة أقرب إلى الوعظ أو التلقين.
المشهد داخل هذه اللقاءات لا يكون متجانسًا. فهناك من يحضر دون فهم حقيقي لما يُطرح، إما بدافع الظهور أو المجاملة الاجتماعية، وهناك من يأتي برغبة صادقة في التعلم والمعرفة. لكن وسط الزحام، وطول الحديث، وغياب التنظيم، يفقد كثيرون قدرتهم على التركيز أو الفهم، فتضيع الفائدة، ويتحوّل الحضور من مشاركة واعية إلى مجرد وجود جسدي.
تزداد الإشكالية حين يكون أسلوب الضيف نفسه طاردًا. حديث طويل، لغة معقدة، أو استعراض للتجربة دون مراعاة للمتلقي. ورغم شعور الملل، يجد الحضور أنفسهم مضطرين إلى المجاملة، والتصفيق، وإبداء الإعجاب، لا لأن ما قُدّم كان ملهمًا، بل لأن ثقافة المجاملة أصبحت جزءًا من المشهد الأدبي.
المشكلة لا تكمن في اختلاف مستويات الحضور، فهذا طبيعي، بل في إدارة اللقاءات دون مراعاة لهذا التنوع. حين يُفترض أن يفهم الجميع المستوى نفسه، وحين يُترك الحوار دون توجيه، تضيع الفكرة، ويُقصى من جاء بحثًا عن المعرفة الحقيقية.
اللقاء الأدبي الناجح هو الذي يوازن بين العمق والبساطة، ويمنح الحضور مساحة للفهم والسؤال، لا مجرد الاستماع الصامت. هو لقاء يُدار بحس ثقافي، لا بروتين مكرر، ويقدّم الأدب بوصفه تجربة حية، لا واجبًا اجتماعيًا.
رتابة اللقاءات الأدبية ليست قدرًا محتومًا، لكنها نتيجة خيارات. وحين تُراجع هذه الخيارات بوعي، يمكن للأدب أن يستعيد مكانه كمساحة للدهشة، لا كمنصة للمجاملات.