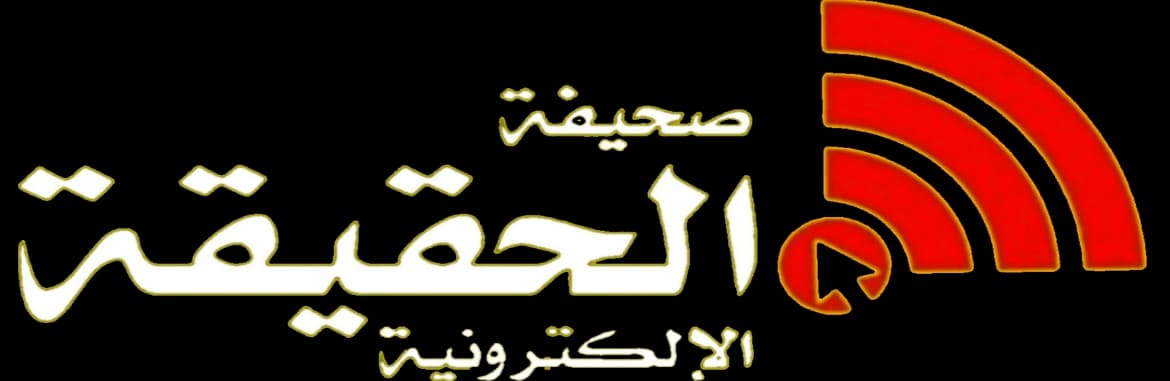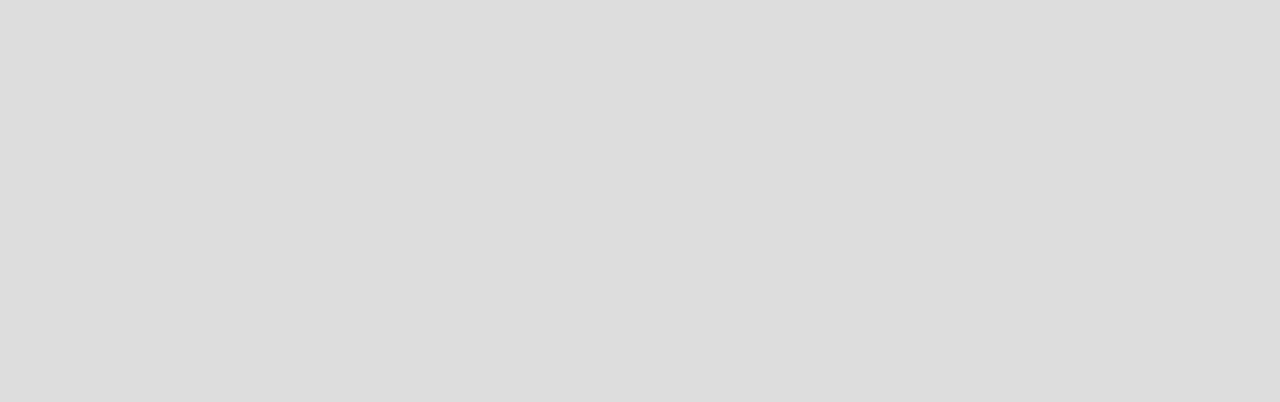تأملات في ملامح الإنسان بين الموج والصخر

بقلم - عبدالعزيز الرحيل
ما من ريبٍ أن الجغرافيا ليست صامتة كما يُخيّل، بل هي كائن حيّ يهمس في أعماق البشر، يُعيد تشكيل ملامحهم الداخلية كما تنحت الرياح وجوه الجبال وتُسطّر الأمواج على الرمال قصائدها العابرة.
فليس عبثاً أن نرى أهل “السواحل يميلون إلى اللين”، كأنّ في داخلهم ظلًّا مائيًّا ينساب برقة ويتراجع بحياء، كما الجزر بعد المد.
فهم أبناء الأفق المفتوح والعناصر المتحاورة بين الزَبَد والنسيم والشمس الوهاجة ، تربّوا على رائحة الموانئ التي لا تعرف الانغلاق، وعلى مرأى السفن التي ترحل وتعود، وقد حملت على أشرعتها ثقافات ومرويات وأساليب حياة جعلتهم أكثر تقبلاً للآخر وأقرب إلى روح التسامح.
لقد لمس أفلاطون في “محاورة طيماوس” أثر البيئة في تشكيل الروح البشرية، حين أشار إلى أن عناصر الطبيعة تُترجم في النفس صورًا من الانفعال والتجاوب، فالذي نشأ عند البحر، تنطبع فيه صفات الموج: التقلّب حينًا، والهدوء العميق حينًا آخر، ويغدو أكثر مرونة في وجه التغيير.
أما الفيلسوف الإغريقي هيراقليطس، الذي رأى في الماء أصلًا لكلّ شيء، فقد قال: “لا يمكنك أن تخوض النهر نفسه مرتين، لأنك لست أنت، ولا النهر هو ذاته.”
وفي هذا حكمة جليلة عن كيف يغدو الإنسان المائيُّ كالبحر، يتجدد كل لحظة، ويتشكل وفق نداءات التغيير.
وفي الشعر الجاهلي، لطالما كانت علاقة الإنسان بالمكان وثيقة الروح والذاكرة، فالشاعر الجاهلي ابن البيداء والقفار، يعلّق قلبه بالأطلال والسراب، ويُجسّد الصلابة في الأبيات كما يجسّد الظمأ العاطفي في ندرة المطر. لكن حين اقترب بعضهم من البحر، تغيّر النَفَس وتسرّبت في ألفاظهم ليونة مختلفة.
لنأخذ مثلًا من امرئ القيس، الشاعر الجاهلي الذي ارتحل كثيرًا، واقترب في بعض رحلاته من السواحل اليمنية، ويُقال إنه ركب البحر في نهايات حياته، ويتجلّى في بعض أبياته مسحة من رقّة ليست مألوفة تمامًا في شعر الصحراء:
أفاطم مهلاً بعض هذا التدللِ
وإن كنتِ قد أزمعتِ صرمي فأجملي
هنا تظهر ليونة في المخاطبة، وتوسّل فيه شيء من اللين لا من التحدي، وكأنه ينظر من حافة الرمال إلى امتدادٍ آخر أبعد من المألوف
وبينما يُصقل الساحليّ بالماء والضوء، يُهذّب الصحراوي بالصمت والرمل، ويتشكّل الجبليُّ من صلابة الصخر وتقطّعات الصوت وسط المدى.
إنّ أبناء الصحارى أو الشعاب الجبلية يُنحتون بأزاميل القسوة، فتُربّيهم العزلة ويعلّمهم المناخ القاسي أن الوجود ليس وعدًا بل اختبار مستمر. كل شيء في بيئتهم يستدعي الصمود، فالريح لا تهبّ لتحمل عنهم عبء الطريق، ولا ظلّ يواسيهم من قيظٍ أو زمهرير. لذا تجدهم متماسكين في طباعهم، صارمين في مواقفهم، تتسم أقوالهم بالحدّية، وقراراتهم بالجزم، لا لأنهم يفتقرون إلى الرحمة، بل لأنّ البقاء هناك مشروط بالحزم، والتودد الزائد لا يروي عطشًا ولا يدرأ ضياعًا.
وما بين البحر والصخر، وبين الانفتاح والانغلاق، يولد الإنسان ابن المكان، حاملًا في سلوكه بصمة الأرض التي أنشأته. فالجغرافيا لا تصوغ التضاريس فحسب، بل تنسج وجدان الناس، وتلوّن أمزجتهم، وتشكّل طبائعهم. تغدو الرقّة ميراثًا بحريًّا، والقوّة تركةً جبلية، وتكون السعة في الأفق مرآة للامتداد الأرضي، كما تكون العزلة انعكاسًا لعالمٍ تضيق فيه الدروب وتتراكم فيه الوحشة.
ولعلّ في تأمّل الجغرافيا مدخلًا لفهم الفوارق التي لا تفسّرها اللغة، ولا تحصيها العادات، بل تُلملمها الأرض وتعيد بثها في هيئة بشرٍ يظنون أنهم اختاروا طباعهم، بينما هي قد اختارتهم منذ أول خطوة على ترابها.
وكما قال محمود درويش ذات مساءٍ:
“كلّما ابتعدتُ عن البحرِ وجدتني أقلَّ، وكلّما اقتربتُ من الرملِ سمعتُ الأرضَ تهمس بما لم يُقَلْ.”
وفي ثنايا هذا الهمس، قد نفهم الحقيقة الغائرة في عبارة غاستون باشلار:
الماء هو المادة التي تعانق الأحلام، تغسل القسوة، وتعيد للروح صفاءها البدائي
من يعيش قربه، يعيش في حضرة التبدّل والاتساع والانفتاح، فيتعلم الإصغاء لا الصراخ، والتكيّف لا الجمود، كأن البحر يربّي في الإنسان طقسًا نفسيًا خاصًا، يجعله أكثر قبولًا للآخر وأكثر انفتاحًا على احتمالات الحياة.
فلعلّ الإنسان لا يسكن المكان، بل المكان هو من يسكن الإنسان .
فليس عبثاً أن نرى أهل “السواحل يميلون إلى اللين”، كأنّ في داخلهم ظلًّا مائيًّا ينساب برقة ويتراجع بحياء، كما الجزر بعد المد.
فهم أبناء الأفق المفتوح والعناصر المتحاورة بين الزَبَد والنسيم والشمس الوهاجة ، تربّوا على رائحة الموانئ التي لا تعرف الانغلاق، وعلى مرأى السفن التي ترحل وتعود، وقد حملت على أشرعتها ثقافات ومرويات وأساليب حياة جعلتهم أكثر تقبلاً للآخر وأقرب إلى روح التسامح.
لقد لمس أفلاطون في “محاورة طيماوس” أثر البيئة في تشكيل الروح البشرية، حين أشار إلى أن عناصر الطبيعة تُترجم في النفس صورًا من الانفعال والتجاوب، فالذي نشأ عند البحر، تنطبع فيه صفات الموج: التقلّب حينًا، والهدوء العميق حينًا آخر، ويغدو أكثر مرونة في وجه التغيير.
أما الفيلسوف الإغريقي هيراقليطس، الذي رأى في الماء أصلًا لكلّ شيء، فقد قال: “لا يمكنك أن تخوض النهر نفسه مرتين، لأنك لست أنت، ولا النهر هو ذاته.”
وفي هذا حكمة جليلة عن كيف يغدو الإنسان المائيُّ كالبحر، يتجدد كل لحظة، ويتشكل وفق نداءات التغيير.
وفي الشعر الجاهلي، لطالما كانت علاقة الإنسان بالمكان وثيقة الروح والذاكرة، فالشاعر الجاهلي ابن البيداء والقفار، يعلّق قلبه بالأطلال والسراب، ويُجسّد الصلابة في الأبيات كما يجسّد الظمأ العاطفي في ندرة المطر. لكن حين اقترب بعضهم من البحر، تغيّر النَفَس وتسرّبت في ألفاظهم ليونة مختلفة.
لنأخذ مثلًا من امرئ القيس، الشاعر الجاهلي الذي ارتحل كثيرًا، واقترب في بعض رحلاته من السواحل اليمنية، ويُقال إنه ركب البحر في نهايات حياته، ويتجلّى في بعض أبياته مسحة من رقّة ليست مألوفة تمامًا في شعر الصحراء:
أفاطم مهلاً بعض هذا التدللِ
وإن كنتِ قد أزمعتِ صرمي فأجملي
هنا تظهر ليونة في المخاطبة، وتوسّل فيه شيء من اللين لا من التحدي، وكأنه ينظر من حافة الرمال إلى امتدادٍ آخر أبعد من المألوف
وبينما يُصقل الساحليّ بالماء والضوء، يُهذّب الصحراوي بالصمت والرمل، ويتشكّل الجبليُّ من صلابة الصخر وتقطّعات الصوت وسط المدى.
إنّ أبناء الصحارى أو الشعاب الجبلية يُنحتون بأزاميل القسوة، فتُربّيهم العزلة ويعلّمهم المناخ القاسي أن الوجود ليس وعدًا بل اختبار مستمر. كل شيء في بيئتهم يستدعي الصمود، فالريح لا تهبّ لتحمل عنهم عبء الطريق، ولا ظلّ يواسيهم من قيظٍ أو زمهرير. لذا تجدهم متماسكين في طباعهم، صارمين في مواقفهم، تتسم أقوالهم بالحدّية، وقراراتهم بالجزم، لا لأنهم يفتقرون إلى الرحمة، بل لأنّ البقاء هناك مشروط بالحزم، والتودد الزائد لا يروي عطشًا ولا يدرأ ضياعًا.
وما بين البحر والصخر، وبين الانفتاح والانغلاق، يولد الإنسان ابن المكان، حاملًا في سلوكه بصمة الأرض التي أنشأته. فالجغرافيا لا تصوغ التضاريس فحسب، بل تنسج وجدان الناس، وتلوّن أمزجتهم، وتشكّل طبائعهم. تغدو الرقّة ميراثًا بحريًّا، والقوّة تركةً جبلية، وتكون السعة في الأفق مرآة للامتداد الأرضي، كما تكون العزلة انعكاسًا لعالمٍ تضيق فيه الدروب وتتراكم فيه الوحشة.
ولعلّ في تأمّل الجغرافيا مدخلًا لفهم الفوارق التي لا تفسّرها اللغة، ولا تحصيها العادات، بل تُلملمها الأرض وتعيد بثها في هيئة بشرٍ يظنون أنهم اختاروا طباعهم، بينما هي قد اختارتهم منذ أول خطوة على ترابها.
وكما قال محمود درويش ذات مساءٍ:
“كلّما ابتعدتُ عن البحرِ وجدتني أقلَّ، وكلّما اقتربتُ من الرملِ سمعتُ الأرضَ تهمس بما لم يُقَلْ.”
وفي ثنايا هذا الهمس، قد نفهم الحقيقة الغائرة في عبارة غاستون باشلار:
الماء هو المادة التي تعانق الأحلام، تغسل القسوة، وتعيد للروح صفاءها البدائي
من يعيش قربه، يعيش في حضرة التبدّل والاتساع والانفتاح، فيتعلم الإصغاء لا الصراخ، والتكيّف لا الجمود، كأن البحر يربّي في الإنسان طقسًا نفسيًا خاصًا، يجعله أكثر قبولًا للآخر وأكثر انفتاحًا على احتمالات الحياة.
فلعلّ الإنسان لا يسكن المكان، بل المكان هو من يسكن الإنسان .